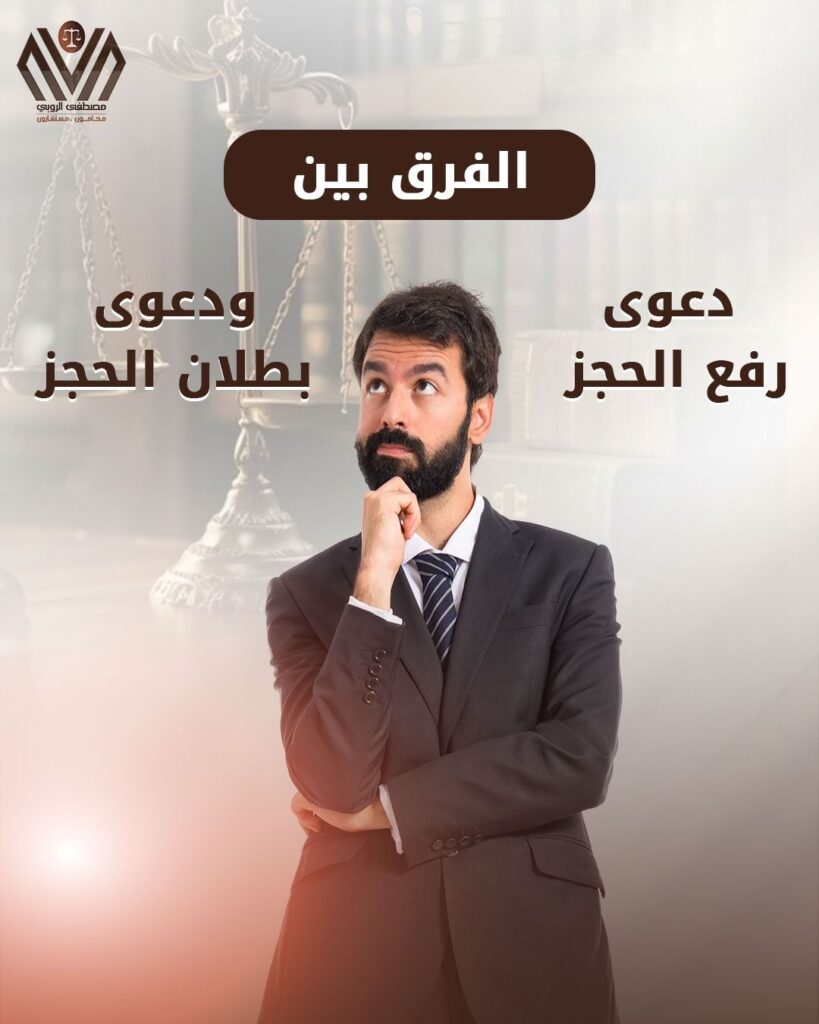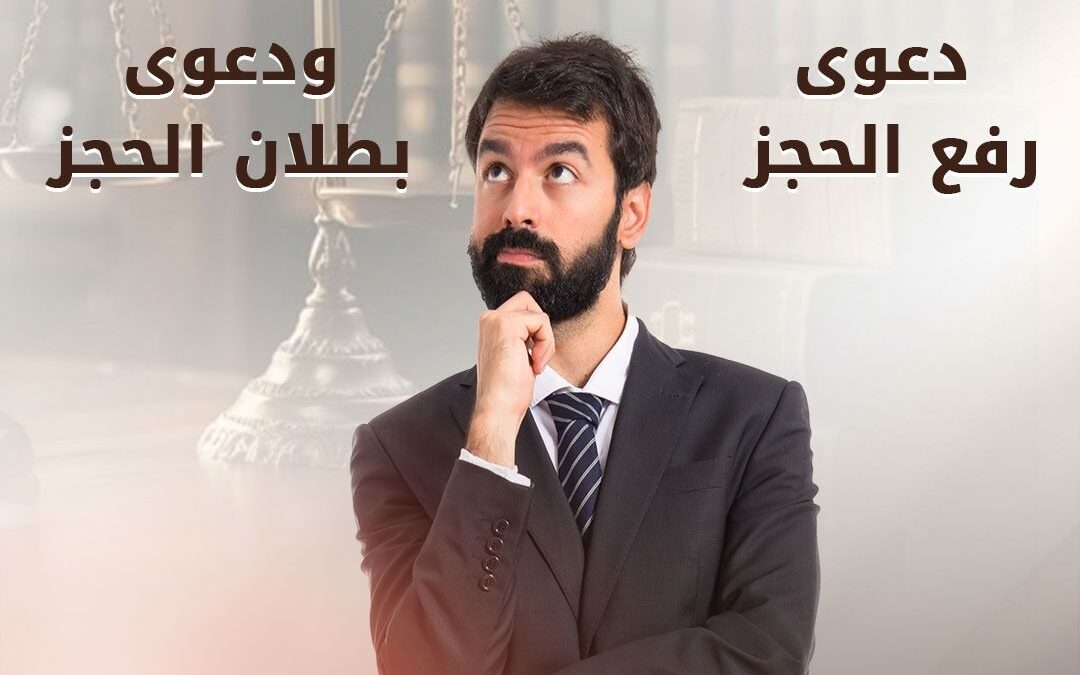بقلم الأستاذ/ مروان الهواري
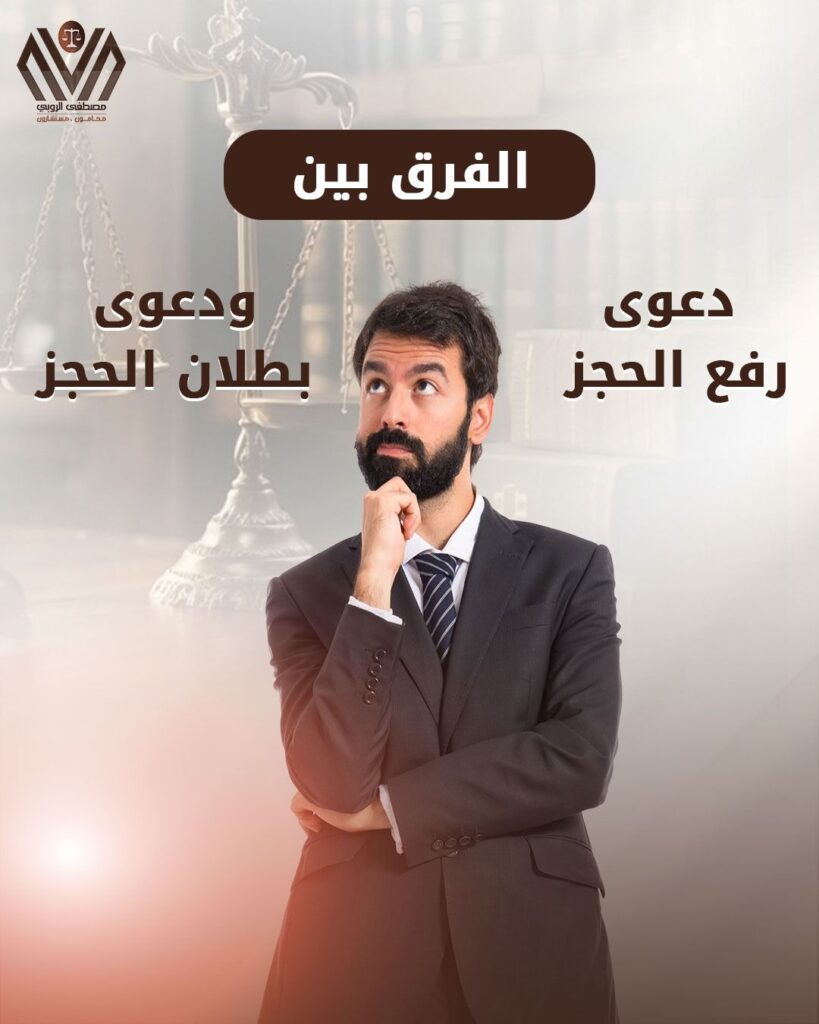
يمثل نظام الحجز حجر الزاوية في منظومة التنفيذ الجبري في القانون المصري، فهو الوسيلة القانونية التي تضع أموال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لاقتضاء حق الدائن جبراً عنه. وتتعدد صور الحجز بحسب الغاية منه، فمنه الحجز التحفظي الذي يهدف إلى منع المدين من تهريب أمواله، والحجز التنفيذي الذي يُعد أولى خطوات بيع المال جبراً، والحجز الإداري الذي يُعد امتيازاً ممنوحاً لجهات الإدارة لتحصيل مستحقاتها. ومن كل هذه الإجراءات التي تمس ذمة المدين المالية ، كفل المشرع للمحجوز عليه ولكل ذي مصلحة أساليب قضائية للدفاع عن حقوقه، تبرز من بينها دعويان محوريتان هما: دعوى رفع الحجز ودعوى بطلان الحجز.
وعلى الرغم من أن الهدف الظاهري لكلا الدعويين هو التخلص من الحجز وآثاره، إلا أن الخلط بينهما في الممارسة العملية والقانونية يمثل إشكالية حقيقية ، حيث أن الدعويان يختلفان اختلافاً جوهرياً في الطبيعة القانونية، والأسباب التي تؤسس عليها كل دعوى، والآثار المترتبة على الحكم الصادر في كل منهما ، فدعوى البطلان تهدم إجراء الحجز من أساسه وتعتبره كأن لم يكن، بينما دعوى الرفع تفترض صحة الحجز ابتداءً وتنهي آثاره لأسباب طرأت بعد توقيعه.
فمن خلال هذه المقالة نهدف إلى تقديم تحليل قانوني متعمق ، يزيل اللبس ويكشف عن الفروق الجوهرية بين الدعويين، مستنداً إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الحجز الإداري، ومتعمقاً في المبادئ التي أرستها محكمة النقض المصرية باعتبارها المرجعية العليا في تفسير القانون وتطبيقه.
أولاً: ماهية دعوى بطلان الحجز وأساسها القانوني.
تُعد دعوى بطلان الحجز إحدى أهم صور منازعات التنفيذ الموضوعية التي يرفعها المحجوز عليه أو كل صاحب مصلحة، بهدف الحصول على حكم قضائي يهدر إجراء الحجز ويعتبره كأن لم يكن، وذلك لوقوع عيب جوهري فيه عند نشأته حال دون اكتماله صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ، فهي دعوى لا تنازع في أصل الحق المدعى به ، بل تنصب مباشرة على صحة إجراءات التنفيذ والحجز ذاتها.
والأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوى هو النظرية العامة للبطلان الإجرائي التي أرساها قانون المرافعات المدنية والتجارية. فالمشرع لم ينص استقلالا على دعوى بطلان الحجز، بل تركها للقواعد العامة لتنظمها.
حيث نصت المادة 20 من قانون المرافعات على أن: ” يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابَهَ عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء”
وبتحليل هذه المادة، يتضح أن البطلان الإجرائي له مصدران: الأول هو البطلان القانوني أو المنصوص عليه في القانون، حيث يحدد المشرع جزاء البطلان صراحة عند مخالفة إجراء معين ، والثاني هو البطلان القضائي ، حيث يستنبط القاضي البطلان من عدم تحقق الغاية التي شرع الإجراء من أجلها ، حتى لو لم يوجد نص صريح يقضي بالبطلان ، ودعوى بطلان الحجز هي التطبيق العملي لهذه النظرية في مجال التنفيذ الجبري.
وتجدر الأهمية هنا في أن نميز بين “دعوى البطلان” كدعوى أصلية و”الدفع بالبطلان” كوسيلة دفاع ، فالدفع بالبطلان، وفقاً للمادة 108 من قانون المرافعات، هو دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه ، وهو وسيلة دفاعية يستخدمها المدين في مواجهة دعوى أخرى يرفعها الدائن ، كدعوى صحة الحجز مثلاً ، أما دعوى البطلان الأصلية ، فهي منازعة موضوعية في التنفيذ ينازع بها المحجوز عليه إجراء الحجز بشكل مباشر ومستقل ، وهي لا تخضع لقواعد سقوط الدفوع الشكلية ، فمن خلال هذا التمييز يكون للمدين الخيار: إما أن ينتظر دعوى الدائن ويدفع فيها بالبطلان كدفع إجرائي، أو أن يبادر هو برفع دعوى أصلية ببطلان الحجز.
ثانياً: أسباب بطلان الحجز (الأسباب الشكلية والموضوعية).
تتنوع الأسباب التي يمكن أن يبنى عليها طلب بطلان الحجز، ويمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين: أسباب موضوعية تمس أركان الحجز الجوهرية، وأسباب شكلية تتعلق بمخالفة الإجراءات التي رسمها القانون.
- : الأسباب الموضوعية.
وهي العيوب التي تصيب الحجز في كيانه أو محله أو سببه، وتجعله منعدم الأثر قانوناً ، ومن أبرز هذه الأسباب:
- انعدام صفة أو مصلحة أطراف الحجز: كأن يوقع الحجز على مال مملوك للغير وليس للمدين ، أو أن يوقعه شخص ليس له صفة الدائن ، فالمصلحة القائمة التي يقرها القانون هي شرط لقبول أي دعوى أو إجراء، وفي حالة عدم وجودها كان الإجراء باطلاً عملاً بنص المادة 3 من قانون المرافعات.
- عدم قابلية المال المحجوز عليه للحجز قانوناً: حدد المشرع على سبيل الحصر أموالاً لا يجوز الحجز عليها حمايةً لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو للمصلحة العامة ، وتشمل هذه الأموال ما يلزم المدين ومن يعول لمعيشته، والأموال العامة المملوكة للدولة، وغيرها من الأموال التي نص القانون على عدم جواز حجزها ، وأي حجز يقع على هذه الأموال يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
جــ – بطلان السند التنفيذي أو انعدامه: الحجز التنفيذي لا يوقع إلا بموجب سند تنفيذي ، فإذا كان السند الذي تم الحجز بموجبه باطلاً في ذاته كأن يكون حكماً منعدماً ، فإن ما بني على باطل فهو باطل، ويكون الحجز بالتالي باطلاً.
د – تخلف شروط الدين المحجوز من أجله: يشترط في الدين الذي يوقع الحجز التحفظي لاقتضائه أن يكون محقق الوجود وحال الأداء ، فإذا كان الدين احتمالياً أو معلقاً على شرط لم يتحقق، أو لم يحل أجله بعد ، فإن الحجز الموقع ضماناً له يكون باطلاً لانعدام أساسه.
ثانياً: الأسباب الشكلية.
وهي العيوب التي تتعلق بمخالفة القواعد الإجرائية التي فرضها القانون لضمان صحة الحجز وحماية حقوق أطرافه ومن أهمها:
- العيوب الجوهرية في محضر الحجز: أوجب القانون بيانات جوهرية يجب أن يشتمل عليها محضر الحجز، مثل ذكر السند التنفيذي، وتعيين موطن مختار للحاجز، ووصف تفصيلي للأشياء المحجوزة، وتعيين حارس عليها ويترتب على إغفال أي من هذه البيانات الجوهرية البطلان.
ب – مخالفة المواعيد الإجرائية : وضع المشرع مواعيد إجرائية يترتب على عدم مراعاتها جزاء هو اعتبار الحجز “كأن لم يكن”. ومن أبرز هذه الحالات:
_ في الحجز التحفظي الموقع بأمر من القاضي، يجب على الحاجز رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
_ في حجز ما للمدين لدى الغير، يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
كما أن الحكم ببطلان صحيفة دعوى صحة الحجز ذاتها يؤدي إلى إلغاء كافة الإجراءات اللاحقة وزوال آثارها ، بما في ذلك اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى بشأنه في الميعاد.
جـــ -العيوب المتعلقة بالإعلان: بطلان إعلان السند التنفيذي للمدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ ، أو عدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز في المواعيد المقررة ، يؤدي إلى بطلان إجراءات الحجز اللاحقة.
ثانياً: ماهية دعوى رفع الحجز وأساسها القانوني.
على النقيض من دعوى بطلان الحجز، فإن دعوى رفع الحجز هي دعوى موضوعية يرفعها المحجوز عليه طالباً إنهاء حالة الحجز القائمة على أمواله ، ليس لوجود عيب أصاب الحجز عند توقيعه ، بل لوقوع سبب قانوني لاحق على توقيعه يبرر إنهاء آثاره ، حيث أن هذه الدعوى تفترض من حيث المبدأ أن الحجز قد وقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره ، ولكنها تدفع بزوال المبرر القانوني لاستمراره.
ونظمت المادة 335 من قانون المرافعات دعوى رفع الحجز حيث نصت على: ” يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه، ولا يحتجّ على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أُبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها”.
وبالنظر وتحليل هذا النص نجد أنه لا ينشئ الدعوى فحسب ، بل يرتب أثراً إجرائياً هاماً هو تجميد الأموال لدى المحجوز لديه بمجرد إبلاغه وإعلانه بالدعوى.
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 قد خلا من تنظيم هذه الدعوى ، مما استقر معه قضاء النقض على وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن ، تطبيقاً للمادة 75 من قانون الحجز الإداري ذاته.
ثانياً: الاسباب التي قد تؤدي إلى رفع الحجز.
تستند دعوى رفع الحجز إلى وقائع وأسباب قانونية طرأت بعد توقيع الحجز صحيحاً، وأدت إلى زوال سبب وجوده أو مبرر استمراره ، هذه الأسباب لا تتعلق بصحة الإجراءات بل بجوهر الحق الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه هذا التوجه يؤكد أن دعوى رفع الحجز هي في جوهرها منازعة حول استمرار الحق في التنفيذ، وليس حول سلامة إجراءات التنفيذ ، وبالتالي، فإن الأدلة المطلوبة لإثباتها تختلف جذرياً عن تلك المطلوبة في دعوى البطلان؛ فبينما تتطلب دعوى البطلان إثبات مخالفة إجرائية، تتطلب دعوى الرفع إثبات واقعة مادية أو قانونية غيرت من المراكز القانونية للأطراف، كتقديم مخالصة سداد أو حكم قضائي بإلغاء السند التنفيذي.
ومن أهم أسباب رفع الحجز:
انقضاء الدين المحجوز من أجله: هذا هو السبب الجوهري والأكثر شيوعاً. فالحجز ما هو إلا وسيلة لضمان استيفاء الدين، فإذا انقضى الدين، انقضى معه الحجز تبعاً لذلك. ويتحقق انقضاء الدين بالوفاء الكامل للمبلغ المحجوز من أجله بالإضافة إلى المصروفات ، أو بما يقوم مقام الوفاء كالمقاصة القانونية، أو اتحاد الذمة، أو الإبراء.
تقديم كفالة أو إيداع مبلغ كافٍ: كفل المشرع للمدين وسيلة فعالة لتحرير أمواله المحجوزة مع ضمان حق الدائن، وذلك من خلال إيداع مبلغ من النقود مساوٍ لقيمة الدين المحجوز من أجله والمصاريف في خزانة المحكمة. يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، الذي يصبح مخصصاً لوفاء حق الحاجز.
انحسار القوة التنفيذية عن السند بعد توقيع الحجز: قد يقع الحجز صحيحاً بموجب سند تنفيذي سليم وقت توقيعه، ثم يطرأ سبب لاحق يزيل عن هذا السند قوته التنفيذية ، وأوضح مثال على ذلك هو الحجز بموجب حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل، ثم يصدر حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ففي هذه الحالة يصبح الحجز بلا سند، ويتعين الحكم برفعه.
اتفاق الخصوم على رفع الحجز: يجوز للدائن الحاجز أن يتفق مع المدين المحجوز عليه على رفع الحجز، سواء كان ذلك مقابل تقسيط الدين أو لأي سبب آخر. هذا الاتفاق يكون ملزماً ويوجب على الجهة القائمة بالتنفيذ رفع الحجز.
ثالثاً: التمييز بين الدعويين وإشكالات التنفيذ الوقتية.
من الضروري أيضاً التمييز بين دعوى البطلان ودعوى رفع الحجز من جهة، وإشكالات التنفيذ الوقتية من جهة أخرى، فكلاهما من اختصاص قاضي التنفيذ، ولكن طبيعة كل منهما مختلفة.
حيث أن الإشكال في التنفيذ هو منازعة وقتية بطبيعتها، تهدف إلى الحصول على إجراء تحفظي عاجل بوقف التنفيذ مؤقتاً أو الاستمرار فيه ، وذلك لحين الفصل في النزاع الموضوعي ، ويفصل فيه قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ، حيث يقتصر دوره على بحث ظاهر الأوراق والمستندات دون المساس بأصل الحق.
أما الفارق الجوهري بينه وبين الدعويين محل سالفتي الذكر فيكمن في عدة نقاط:
من حيث الهدف: الإشكال يهدف إلى إجراء وقتي ومؤقت (وقف مؤقت)، بينما دعوى البطلان أو رفع الحجز تهدفان إلى حسم النزاع حول الحجز بشكل نهائي (إلغاء أو إنهاء).
من حيث سلطة القاضي: في الإشكال، سلطة القاضي مقيدة ببحث ظاهر الأوراق. أما في دعوى البطلان أو الرفع، فيفصل قاضي التنفيذ في موضوع المنازعة باعتباره قاضي موضوع ، وله سلطة كاملة في تحقيق الدعوى والتعمق في فحص الأدلة.
من حيث الأثر على التنفيذ: الإشكال الأول المرفوع من المحجوز عليه يوقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه. أما دعوى الرفع ودعوى البطلان فلا توقفان التنفيذ بمجرد رفعهما (مع استثناءات كدعوى الاسترداد)، بل يجب صدور حكم بذلك من القاضي ، وإن كانت دعوى رفع الحجز يترتب على إعلانها للمحجوز لديه منعه من الوفاء للدائن بدينه لحين الفصل في الموضوع.
خاتمة:
خلاصة القول فإن التمييز بين دعوى رفع الحجز ودعوى بطلان الحجز يتجاوز كونه مجرد تفصيل إجرائي ليصبح فارقاً جوهرياً يحدد مسار النزاع ونتائجه القانونية المترتبة عليه ، فدعوى البطلان، بطبيعتها “الكاشفة”، تهدم إجراء الحجز من أساسه بأثر رجعي، معتبرة إياه كأن لم يكن لوجود عيب أصيل شاب نشأته ، أما دعوى الرفع بطبيعتها “المنشئة”، فهي تنهي حجزاَ وُقّع صحيحاً ولكن لأسباب طرأت لاحقاً، ويكون لحكمها أثر فوري ومستقبلي.